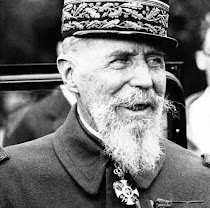المسيحية السياسية: مقدمة موجزة لمبحث لا بد منه

الكتابات حول ما يصطلح عليه نظريا بالإسلاموية أو التطبيقات الإشكالية للحركية الإسلامية السياسية تكاد لا تعد ولا تحصى. كل يوم، ومع كل فاجعة جديدة، يطلع علينا من يتوسل عن حق أو باطل (كل حسب نيته) استقراء واقع الأمة الإسلامية، لا لإفادتها وإعانتها على النهوض، بل لتعييرها بما وصلت إليه من "انحطاط وهزيمة" مفترضتين وتحميلها مسؤوليات جسام، لا ناقة ولا جمل لها فيها، فيما يسمى بحوار الحضارات. وكأن الكون كله يدور حول المسلمين والإسلام والإسلام السياسي! بئس الإختزاليات النظرية. بئس قبحها وجرأتها على الناس. أليس من المعيب فكريا وأخلاقيا مجافاة العلوم الإنسانية والإجتماعية المطلوبة لفهم واقعنا والإستعاضة عنها بخطابات كراهية جوفاء ودعوات فردية وجماعية لوضع المسلمين (من أقصى إندونيسيا إلى آخر ولاية في كندا) في قفص الإتهام؟ أين ذهبت البنى والتراكيب الإجتماعية؟ هل من مجيب يعيد الرشاد إلى نقاشات الإسلام السياسي، تعديلا وتصويبا ونقلا للجدل المستمر من دائرة سؤال المسؤوليات الفردية والجماعية إلى دائرة سؤال البنى المجتمعية والتراكيب الثقافية والتلاقح المفاهيمي بين الجغرافي والسياسي؟ وعلى قاعدة أن ...